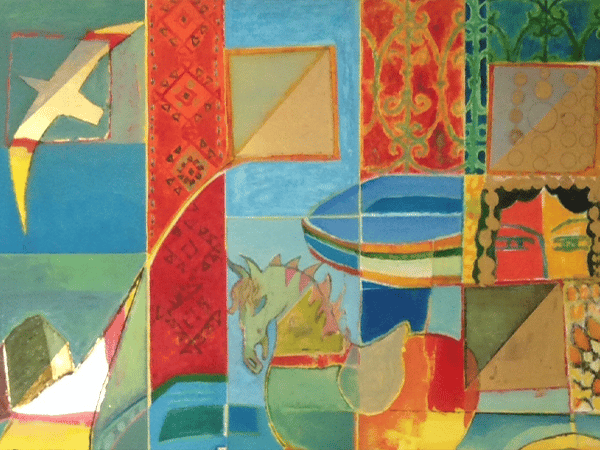للسلطة (power)مظاهر وتجليات متعددة، فهناك السلطة السياسية والسلطة التعليمية والسلطة الصحية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة الجمركية والسلطة الأبوية داخل الأسرة وغيرها من السلطات. والملاحظ هنا أن السلطة، في كل تجلياتها، مرتبطة باللسان، أو langue بالفرنسية وبالإنجليزية language، سواء أكان هذا اللسان شفاهياً أو مدوناً. وهذا الارتباط عضوي وتكويني ولا انفكاك له؛ فلا ممارسة للسلطة من دون لسان، ولا وجود للممارسات اللسانية من دون أن تنتج نوعاً من السلطة أو نوعاً من الإخضاع لسلطة ما. ويتحدث رولان بارت عن تعدد صور خطاب السلطة فيقول إنه، شخصياً، يعتقد أن “خطاب السلطة [هو] كل خطاب يولد الخطأ عند من يتلقاه، وبالتالي الشعور بالإثم. ينتظر منا البعض، نحن المثقفين، أن نقوم، في كل مناسبة، ضد السلطة بصيغة المفرد، بيد أن معركتنا تدور خارج هذا الميدان؛ إنها تقوم ضد السلطة في أشكالها المتعددة. وليست هذه بالمعركة اليسيرة: ذلك أنه إن كانت السلطة متعددة في الفضاء الاجتماعي، فهي بالمقابل، ممتدة في الزمان التاريخي. وحينما نبعدها وندفعها هنا، سرعان ما تظهر هناك؛ وهي لا تزول البتة. قم ضدها بثورة بغية القضاء عليها، وسرعان ما تنبعث وتنبت في حالة جديدة، ومرد هذه المكابدة والظهور في كل مكان هو أن السلطة جرثومة عالقة بجهاز يخترق المجتمع ويرتبط بتاريخ البشرية في مجموعه، وليس بالتاريخ السياسي وحده. هذا الشيء الذي ترتسم فيه السلطة، ومنذ الأزل، هو اللغة، أو بتعبير أدق: اللسان.”1
إذن، فإن العلاقة بين السلطة واللسان أو “اللغة” علاقة متأصلة وجودياً في مفهومي السلطة واللسان وليست طارئة. ومما لا شك فيه أن السلطات المتعددة ذات طبيعة هرمية؛ فتكون السلطة السياسية في الأعلى، وتتدرج مستويات ممارسة السلطة نزولاً إلى سلطة صاحب العمل على من يعملون لديه، وسلطة الأب أو الأم في البيت… إلخ. وعلى الرغم من الطبيعة الهرمية للسلطة، فإننا قد نلاحظ نوعاً من تقسيم السلطات أو توازيها أو توازنها، أو حتى تنازع السلطات أو قيام إحدى السلطات الأدنى بالتمرد على السلطة الأعلى. ولعل الانقلابات أو مظاهر التمرد المسلح أو الشعبي نمطان تاريخيان مهمان من أنماط تآكل هيبة السلطة في أعلى الهرم أو تناقضها في صراعها الأبدي مع السلطات الأخرى في البلد الواحد. وفي فقه القانون ليست متون القوانين سوى مدونات كتابية صامتة، قد يبدو أنها لا حول لها ولا قوة؛ ولكن الفحص الدقيق يثبت أن لهذه المدونات قوة تترتب عليها أحكام شتى، فهذه المدونات نفسها هي من توكل للسلطات التنفيذية أمر تنفيذ أحكامها بعد اكتسابها درجة البتات. وهناك مصطلح مهم في الفقه القانوني يسمى تنازع القوانين. ومفهوم التنازع يحيل بالضرورة إلى مفهوم السلطة. ويفهم منه وجود قوانين تنص على أحكام متناقضة أو غير متطابقة بخصوص موضوع معين أو وجود أحكام مختلفة تعالج حالة بعينها في قوانين مختلفة مما يستلزم اللجوء إلى المحاكم العليا للفصل في أي الإحكام واجب النفاذ وأيها ينبغي تعطيله. وفي حال نشوء تناقض بين نصوص القوانين وأحكام الدستور الذي يمثل المدونة القانونية الأسمى في البلاد فإن تلك القوانين تعد باطلة، أي لا سلطة لها. وبما أن الدستور وكل القوانين ليست سوى مدونات لسانية، فإننا نتفق مع ما ذهب إليه بارت من أن “اللسان، من حيث هو إنجاز كل لغة، ليس بالرجعي ولا بالتقدمي. إنه، بكل بساطة فاشي: ذلك لأن الفاشية ليست هي الحيلولة دون الكلام، وإنما هي الإرغام عليه.”2 وهنا تلوح السلطة المتضمنة في الكلام في الممارسة اليومية؛ فكم هي الأمور التي ترغمنا اللغة المدونة أو المنطوقة على تنفيذها؟
يقول جوزيف كونراد في رواية (لورد جيم) “إن مهمتي، التي أحاول أن أنجزها، هي أن أجعلك، من خلال سلطة الكلمة المكتوبة، أن تسمع، أن تشعر، وقبل هذا وذاك، أن أجعلك ترى.” ولكن السؤال هو من الذي يحدد ما تسمعه أو تشعر به أو تراه؟ لا شك أنه الكاتب وهو يمارس سلطته القهرية في أن يجعلك تسمع وتشعر وترى ما يريده هو، ومن الزاوية التي يقررها هو. ببساطة إنه يختار مدخلات الحواس التي ستحدد وعيك وموقفك، وهذا هو عين الموقف الفاشي الذي تمارسه الكتابة بوصفها أحد أهم تجليات الكلام البشري.
يفرض تعدد تجليات السلطة ومظاهرها المختلفة لفت الانتباه إلى تعدد مستويات العلاقة بين السلطة والكتابة من جهة، والتعقيد الشديد لتداخل هذه المستويات من جهة أخرى. وإذا كانت السلطة السياسية تمثل المظهر الأهم من مظاهر السلطة وتجلياتها لأنها تستطيع أن تؤثر، على نحو أكبر وأعمق، في أنواع السلطة الأخرى، فإن البحث في علاقة المظاهر الأخرى بالمظهر الأهم سوف تظهر مدى التشابك والتعقيد اللذين يكتنفان علاقة السلطة بالكتابة. إذن، فإن السؤال المهم سيكون: ما المقصود بالسلطة وبالكتابة؟ ويمكن أن يتولد منه سؤال مهم آخر ألا وهو: أليس للكتابة من سلطة؟ فالكتابة بوصفها ممارسة فكرية موضوعها الأول أبعاد التجربة الوجودية للإنسان وعلاقته بأخيه الإنسان ستشكل نمطاً خاصاً من مظاهر ممارسة السلطة. والحقيقة التي مراء فيها أن كل كتابة، سواء أكانت في الأدب والفكر، أم في العلوم الصرفة والتطبيقية، لا بد لها أن تنطوي على بعد أيديولوجي ما، حتى ليمكن القول إن الكتابة قد تمارس نوعاً من السلطة المضادة للسلطة القائمة بما تملك من قوة حجاج وإقناع مما يترك تأثيراً معيناً في الرأي العام قد يناقض رأي السلطة السياسية القائمة. فالأنظمة السياسية كافة تدرك أن الكتابة خارج إطار السلطة القائمة ومفاهيمها يمكن أن تكون تمهيداً لقيام سلطة جديدة مناقضة. ولعل هذا هو السبب وراء نشوء أنظمة سلطوية لمراقبة المطبوعات. إذن، فإن للكتابة سلطتها الواضحة التي تمارس دورها مرتدية قفازات حريرية. وحين تنتصر الأيديولوجيا التي تناصرها الكتابة المضادة وتتحول إلى موقع السلطة القائمة تواً، فإن الكتابة تنتقل إلى موقع الموالاة للسلطة الجديدة، فتنزع الكتابة تلك القفازات الحريرية لترتدي قفازات حديدية، وتبدأ بإجراء تغيير جذري في طبيعة خطابها حسب موقعها الجديد.
كان السوفسطائيون أول من أدرك أهمية سلطة الكلام ومن ثم أهمية الكتابة لكون الأخيرة تمثيل للكلام لا غير، فما الكتابة إلا نوع من الكلام المدون مع ملاحظة أن الكتابة نمط خاص من الكلام الممنهج؛ إنها نوع من التكنولوجيا القهرية الناعمة. وقد مارس السوفسطائيون سلطة الكلام والكتابة في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت محاورات أفلاطون المدونة، وكتابات أرسطو إنموذجين مهمين من سلطة الكتابة المعرفية التي مارسها هذان الفيلسوفان على العمل الفكري والعقلي حتى وقتنا الراهن. ومن خلال مؤلفاتهما المكتوبة، عمل كل من أفلاطون وأرسطو على مناهضة النظرية السوفسطائية من خلال سطوة الكتابة، أو سلطتها، التي أفضت في نهاية المطاف إلى محو القيمة الإيجابية لعمل السوفسطائيين الكلامي غير المدون. ولعل هذا يثبت أرجحية سلطة الكتابة على سلطة الكلام الشفاهي.
إذن، فإن الكُتَّاب، في كتاباتهم، لا يكتفون بتأمل الحياة أو تفسيرها حسب، وإنما هم يقومون، أيضاً، بإثرائها بالمعرفة ومحاولة صوغ شكل الحياة في المستقبل، بمعنى أنهم قد يحاولون الانتقال من محاولة تفسير العالم إلى العمل تغييره كما يرى السيد ماركس؛ وهذا يعني أن للكتابة بعداً سياسياً وأيديولوجياً بالضرورة. ومن هنا فإن سلطة الكتابة ليست مسألة عابرة أو مقصورة على تبعيتها للسلطة السياسية لأن الكتابة نفسها نوع من ممارسة للسلطة الفكرية ذات الأثر الكبير في تحديد مسارات الحياة في المستقبل، ولاسيما مسارات ممارسة السلطة. ومن هنا فإن للكتابة أثراً مهماً في نشأة السلطة القائمة وفي تقديم الدعم الفكري والأيديولوجي لها حين تختار المشي في ركاب تلك السلطة، أي حين تتحول إلى كتابة للسلطة؛ وهي أيضاً قد تعمل على نقض أسس السلطة القائمة حين تختار أن تكون على الضد منها، فتشتبك سلطة الكتابة مع كتابة السلطة في صراع فكري مرير يعبر عن الدور المحوري العظيم الذي تلعبه الكتابة بوصفها أحد أبرز تجليات الصراع الأزلية بين البشر. ويذهب جيل دولوز إلى أبعد من ذلك إذ يقرر أن “الكتابة لا علاقة لها بالمعنى. إنها تتعلق بمسح الأراضي ورسم الخرائط، بما في ذلك رسم خرائط الدول القادمة.” فيكشف بذلك عن البعد السياسي العولمي للكتابة. ونجد الدليل على صحة وجهة نظر جيل دولوز في ما نشره بعض الكتاب السائرين في ركاب أمريكا وإيران وبعض الدول العربية من مقالات وكتب لتسويغ تدمير بعض الدول أو تفكيك وحدتها الوطنية والاجتماعية كما هو الحال في العراق وليبيا وسوريا واليمن ومصر. وهنا لا بد لنا من التنويه بما يقدمه المفكر اللساني والكاتب السياسي الكبير نعوم تشومسكي من مقالات وكتب في محاولة للتصدي كتابة السلطة من خلال بيان المغالطات البنيوية والسياسية والتاريخية التي يقوم عليها خطاب الكُتَّاب السائرين في ركاب السلطة.
وعلى الرغم من أهمية السلطة السياسية وجسامة دورها في الحياة فإنها ليست التحدي الأكبر الذي يواجه ممارسة الكتابة لسلطتها التنويرية؛ ففي أسوأ الأحوال قد تدوم سطوة السلطة لمدة طويلة، ولكن ستتغير، لا محالة، بمرور الزمن؛ وسيتمكن الكتًّاب المدافعون عن سلطة الكتابة من الكشف عن عورات الأنظمة السياسية كافة؛ وسيتظاهر من اختاروا السير في ركاب السلطة من الكتَّاب بأنهم قد خدعوا ونعلم أنهم مخادعون. ولكن الخطر الأعظم يكمن في الصراح بين سلطة المقدس وسلطة الكتابة؛ فالمقدس أكثر شراسة وأعظم دواماً من الأنظمة السياسية كافة. فكيف يمكن النظر إلى علاقة الكتابة بالمقدس؟ و قبل هذا وذاك، ألا يشكل المقدس سلطة متعالية على الشروط التاريخية اللاحقة للحظة تشكله أول مرة؟ وتخبرنا الوقائع التاريخية أن أشد أنواع ممارسة السلطة قسوة وأعظمها جبروتاً قد حدثت باسم المقدس. وليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذا الميل المتأصل في الخطاب الديني سيتغير الآن أو في المستقبل لأنه نتيجة حتمية لتصور الكتَّاب الذين يتبنون الخطاب المقدس أنهم إنما يدافعون عن حقائق مطلقة، وإن كانت الحقيقة والواقع يظهران غير ذلك. فنحن نعلم من خلال فحص الظواهر التاريخية التي تجسد تجليات علاقة الكتابة بالمقدس أن وجود نص مقدس واحد لن يحول دون الاختلاف في الفهم والتأويل، وبالتالي فإنه نسبي الدلالة؛ وما ذلك إلا لأن من أهم خصائص النص المقدس أنه نص موح ومكتوب بأسلوب رمزي ومجازي وهو نص يحفل بالمرويات الأسطورية مما يفتح الباب واسعاً للتأويل الذي قد يصل إلى حد تناقض التأويلات. إذن فإن كل الكتابات المقدسة تمارس سلطتها مدعية أنها إنما تخدم الكيان المطلق الأسمى. أما من حيث أن النص المقدس يمكن أن يوحي بمضامين متناقضة، فلعل مسألة الجبر والاختيار في الإسلام، وطبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت في المسيحية خير مثال على ما يمكن للنص المقدس أن يولد من تأويلات متضاربة. فكل من القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار يستندون إلى النص المقدس نفسه؛ كذا الأمر بالنسبة لمسألة طبيعة المسيح في العهد الجديد. والحقيقة أنه لا يمكن فهم الخلاف بين القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار من دون العودة إلى الظروف السياسية التي صاحبت ظهور هذين الموقفين الذين يعبران عن تصورات سياسية ضمنية متضاربة يدعم طرف منها السلطة القائمة في حين يسعى الطرف الآخر إلى تقويض تلك السلطة.
إذن، ما السبيل إلى حل إشكالية الصراع الأبدي بين كتابة السلطة التي تصطف إلى جانب السلطة القائمة منافحة عنها، وسلطة الكتابة بوصفها تعبيراً عن سلطة تطمح لأن تمسك بمقاليد الأمور؟
يبدو لي أن الأمر هكذا كان، وهكذا هو الآن، وهكذا سيبقى، في صراع بين هذين المفهومين المختلفين لعلاقة السلطة بالكتابة، فهي إذن إشكالية كامنة في صلب النفس البشرية.
. رولان بارت، “السلطة و اللغة” ترجمة ع. ب. (عبد السلام بنعبد العالي) الأنترنيت. مدونة محمد عابد الجابري http://www.aljabriabed.net.
2. المصدر نفسه.
كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل
 المحور العربي
المحور العربي